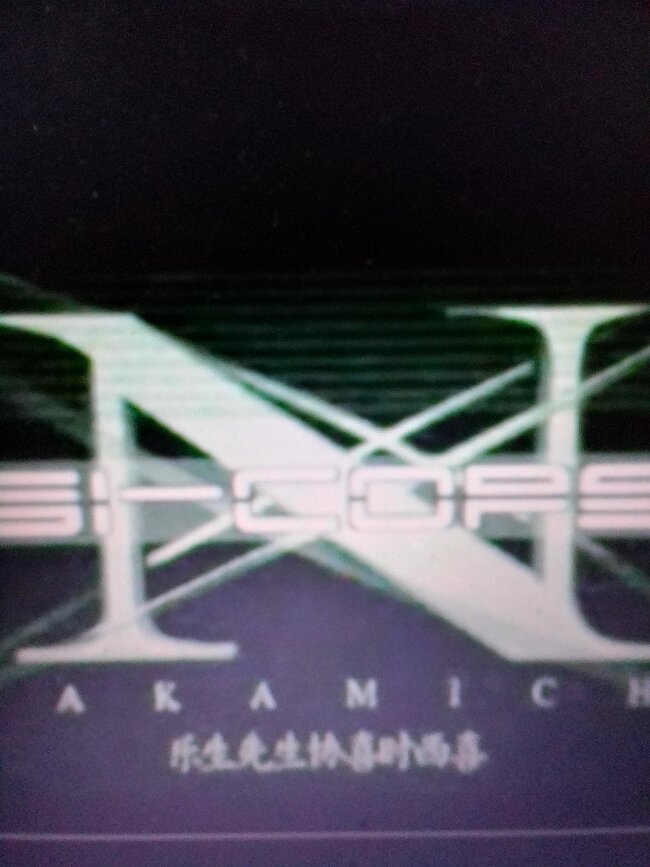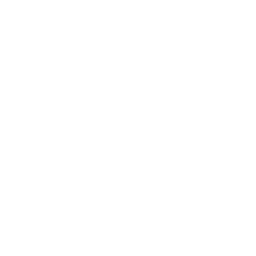سيد الأحجار السبعة
عابر الزمن الثالث
المصفوفة الفيزيائية – التجريدية : الرُّؤية الفيزيائية لقيمية الكون والفرق بين الحقيقة والمعرفة اللغوية { الثوابت والحدود الفيزيائية بين المجالات } :
هنا والآن ... سيتضحُ الفرق الحقيقي بين الفيزياء المبنية على الإدراك ، والفيزياء المؤسسة على لغة المجتمع الوضعية :
من وجهة نظر فيزيائية موضوعية ، ومحلية مُفارِقة للعلل ، تكون الثوابتُ الكونية على هيئة علاقات تناسُب رياضية دقيقة ، تحكُم حركة القوى الفيزيائية الرئيسية بالنسبة لبعضها البعض ضمن النسيج المحلي ، والأنسجة الكونية التي تنبني عليها من المجرات إلى الغلاف الجوي للأرض ، والأنظمة الحيوية الجسدية مثل الدنا والبروتين والأحماض الكربونية ، وصولاً إلى الذّرة نفسها وكمومها الأولية.
فلا تبحث الفيزياء المعروفة في "حقيقة" الظاهرة الفيزيائية ( كالثابت الكوني ) بل في ظهوره الموضوعي القابل للقياس من الآلات التي يستخدمها عدة مراقبين محليين ، وكشف العلاقات التي توجه ساعة الظاهرة بالنسبة للكائنات المحلية الأُخرى القابلة للقياس الموضوعي ، دون الكشف عن كُنه الساعة.
من وجهة نظر فيزيائية موضوعية ، ومحلية مُفارِقة للعلل ، تكون الثوابتُ الكونية على هيئة علاقات تناسُب رياضية دقيقة ، تحكُم حركة القوى الفيزيائية الرئيسية بالنسبة لبعضها البعض ضمن النسيج المحلي ، والأنسجة الكونية التي تنبني عليها من المجرات إلى الغلاف الجوي للأرض ، والأنظمة الحيوية الجسدية مثل الدنا والبروتين والأحماض الكربونية ، وصولاً إلى الذّرة نفسها وكمومها الأولية.
فلا تبحث الفيزياء المعروفة في "حقيقة" الظاهرة الفيزيائية ( كالثابت الكوني ) بل في ظهوره الموضوعي القابل للقياس من الآلات التي يستخدمها عدة مراقبين محليين ، وكشف العلاقات التي توجه ساعة الظاهرة بالنسبة للكائنات المحلية الأُخرى القابلة للقياس الموضوعي ، دون الكشف عن كُنه الساعة.
البابُ الأوّل : أصول مُطلقة قاهرة لعِلم الفيزياء ... الإشكالية الدلالية للمفاهيم العلمية في الفيزياء الحديثة
وعلى عكس توقعاتك ، فإن الفيزياء تعتمد بشكل تام على "المفاهيم الفلسفية" ، ودعني أخبرك الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي بشكل مبسط :
عندما تتكلم عن "المادة" أو "الطاقة" ، الالكترون ، الذرة ، الجاذبية …. فإنك تستخدم مفاهيم ( كليات ) تحتوي خصائص تشترك فيها مجموعة كبيرة ( أو لا نهائية ) من الموضوعات الفيزيائية المحلية ، أي المحددة بزمان ومكان معينين ( بمعنى المجال الذي يتمُ رصدُ التآثر ضمنه في نقطة ظهورٍ معينة ) ، وقديماً كان يقال عن هذا النسيج "الجسم الطبيعي" ، واختلفت المسميات باختلاف مراحل الحضارات ، لكن المعنى العام بقي كما هو. أما عندما تتكلم عن "السببية" أو "الارتياب" ، الفعلية ، الواقعية …. فإنك تقصد بشكل باطن تلك الكليات التي تشمل ( أي ماهية طبيعية يتحدد أفرادها بوجود زمكاني ) وكذلك تشمل ( كل ) ما يقع خارج الوجود الزمكاني ( أي الطبيعي ) إن أمكن وقوع شيء خارجه ( مثل المفاهيم الماهوية من حيث هي مفاهيم لا من حيث ما تنطبق عليه من مصاديق طبيعية ) ولكنك ترتكب المُغالطة ، في اللحظة التي تُعادل فيها بين سببية المُستوى المحلي ، وسببية المُستوى المُطلق.
والقصد من ذلك "الماهية نفسها من حيث هي شيء معقول لا من حيث أفرادها المحسوسين الذين تخبر عنهم" ، وبعبارة أخرى فإن الفيزياء هي "العلم الذي يدرس السلوكيات القابلة للخضوع للمنهج التجريبي الوضعي ، والمنتمية إلى الموضوعات الزمكانية ، وذلك "لينتزع" من هذه السلوكات تلك القوانين العامة التي تحكم هذه الموضوعات" وهذه القوانين العامة هي "المفاهيم الفلسفية عند تطبيقها على الماهيات الطبيعية" والتي تتحول إلى صيغ رياضية نتيجة دخول مقولة "الكم" المتصل والمنفصل والمتخيل إلى تلك الماهيات.
هناك عدة اتجاهات ظهرت في القرن العشرين لتفسير هذه الظاهرة "الفيزيائية الإدراكية" الغريبة ، أشهرها وأكثرها رواجاً وقبولاً بين العلماء هي "الوضعية المنطقية" والتي تدعي أن تلك المعقولات هي "أوهام نشأت عبر ترابط الصور المادية المختزنة في الذاكرة ، وعن عامل الاشتباه". ولست هنا ساعية لمراجعة ونقد ذلك التوجه ، إلا أنه على أي حال ، لا يلغي أهمية هذه المعقولات لكي "تُفهم الفيزياء". يكفي أن تعلم أن "خبراتك الإدراكية الذاتية" لا يمكن التعبير عنها بطريقة حَسوبة أو اختزالية كما تفترض الوضعية، وبالتالي ليس من الدقيق ، أن تصفها بالوهم لمُجرد أن "جُزءً منها\نطاقُ الرصد المحلي" لا يتوافقُ مع كُليتها ، وشموليتها. وإن الحَكَم على الرصد المحلي هو العلم الذاتي وليس العكس.
أقتبس من هذا المقال المُترجم للسيد الموقر ، ديفد بوهم :
«أحجَمَ معظمُ الفيزيائيين عن الخوض بتفسير سببي للنظرية الكوانتية، جزئياً لاعتبارات عَمَلية، وجزئياً لاعتبارات فلسفية؛ استندت على مبدأ اللّاتعيين الشهير لهايزنبرغ، والذي اعتبر علاقات اللّاتعيين (اللّاحتميّة/اللّاديترمينيّة) indeterminacy (كالتي تنص على أنه: كلما تحدّد موضعُ جسيمة بدقّة قلّت دقّة تحديد عزمها وبالعكس) تجسيداً لمبدأ عام أساسيّ وشامل جداً لكلّ شيء، بدل اعتبارها استنتاجاً من النظرية الكوانتية بشكلها الراهن، فزعمَ تمثيلَ هذه العلاقات لقانونٍ أساسيّ للطبيعة وصلاحيتها المطلقة والنهائية، حتى لو خَضعَ الشكل الحالي من النظرية الكوانتية بنهاية المطاف لتصحيح وتوسيع أو حتى لتغيير جذري وثوري. النظرة العامة لدى هايزنبرغ (ومعظم أنصار التأويل المعتاد للنظرية الكوانتية) هي أنّ التطورات المستقبلية بالفيزياء ستنحو باتجاه فرض حدود لا يمكن تجاوزها إطلاقاً لدقّة جميع القياسات الممكنة» – ديفيد بوم (1957)
يفترضون مبدأ اللاتعيين حدّاً مطلقاً ونهائياً يقيّد قدرتنا على تحديد حالة الأشياء بواسطة القياس من أيّ نوعٍ كان، سواء حالياً أو مستقبلاً، مما يوصل إلى نتيجة عميقة العواقب: سيغدو السلوك المستقبلي لمنظومةٍ ما متوقَّعاً فقط إلى تلك الدرجة من الدقة المتوافقة مع حد أقصى يفرضه «مبدأ» اللّاتعيين. وهكذا فنُكران السببية بالتأويل المعتاد للنظرية الكوانتية لا يُعتبر، وفق هذا التأويل، مجرّد نتيجة لعجزنا عن قياس القيم الدقيقة للمتحولات الداخلة بتعبيرات قوانين سببية ذرّية، بل بالأحرى انعكاساً لعدم الوجود الواقعي (وفقاً لهم) لقوانينَ سببية كهذه! لذلك أرى أنْ نطلق مصطلح «اللّاتعيين» أو «اللاحتمية» indeterminacy كوصف ملائمٍ أكثر من تسمية «مبدأ اللّايقين» uncertainty الشائعة، لأنه بقدر ما يتعلّق الأمر بمتحولات مرصودة فيزيائياً، فإنهم لا يفترضونها فقط «لا يقينية» بالنسبة للإنسان (بمعنى عدم قدرته على قياسها بدقة تامّة) بل بالأحرى يتمّ افتراض أسلوب وجودها بذاته «غير مُتَعَيِّن»!
عندما نمضي إلى مستوى ميكانيكي تحت- كوانتي، فإنّ كامل مخطّط المرصودات التي تلبّي قواعد محدّدة ملائمة للمستوى الميكانيكي الكوانتي سوف ينهار، ليُستبدل به آخر مختلف كثيراً. وبهذه الحالة، لن يكون برهان «مُبرهنة فون نيومان» ملائماً، لأنّ الشروط المعتبرة هنا تتخطّى الفُروض الضمنية المطلوبة لتنفيذ البرهان.
وهكذا نرى بأنّه سواء بحالة مبدأ اللّاتعيين أو بمبرهنة فون نيومان، تمّ استقاء النتائج المتعلقة بالحاجة لنُكران السببية والاستمرارية والواقع الموضوعي للمواضيع الميكروية، ليس من الوقائع التجريبية الكامنة بأساس الميكانيك الكوانتي، ولا من المعادلات الرياضية التي تعبّر عن النظرية. بل بالأحرى من فرضية (مضمرة ضمنياً أكثر منها صريحة) بأنّ عناصر محدّدة مرتبطة بالصياغة الحالية للنظرية هي عناصر مطلقة ونهائية، ولا يمكن نقضها بنظريات مستقبلية، ولا يمكن اكتشاف أنّها تقريبات تصحّ فقط بنطاقٍ محدودٍ. إنّ فرضية كهذه، وإذْ تَحدُّ بشدّة الأشكالَ الممكنة لنظريات مستقبلية، تمنعنا من التفكير بمستوى ميكانيكي تحت-كوانتي يمكن أن تجري فيه أنواعٌ جديدة من الحركة تنطبقُ عليها أنواعٌ جديدة من القوانين السببية.
وهكذا يقصرون التفكير المَفاهيمي على النطاق الكلاسيكي، بحيث لا يبقى خارجَه سوى الانخراط بمناورات تقنية بحتة للرموز الرياضية وفقاً لوَصفات مناسبة تكون الشغل الشاغل للفيزيائيين النظريّين لكي يكتشفوها.
يعتقد الفيزيائيون الحديثون: أنّ أزمة الفيزياء الحالية يمكن حلّها بتنقيح تفاصيل الأنواع العامة من النظريات الاحتمالية الرياضية الراهنة. إنّ المشترك بينهم وبين الكلاسيكيين هو الميل إلى افتراض الطابع المطلق والنهائي للعناصر العامّة للنظرية الأكثر أساسية التي يجدونها قائمةً في زمانهم، والتي يشتغلون فيها. وهكذا فإنّ التأويل المعتاد للنظرية الكوانتية يمثّل بمعنىً ما استمراراً طبيعياً للموقف الميكانيكي للفيزيائيين الكلاسيكيين.
ديفيد بوم David Bohm (1917–1992): فيزيائي أمريكي، مؤسِّس تيار في الميكانيك الكوانتي، استرشد عن وعي بالفلسفة العلمية المادية الديالكتيكية في مرحلة من نتاجه، فجاء مناهضاً لمعظم التأويلات المثالية السائدة (كوبنهاغن، الأكوان المتعددة...إلخ) رغم أنّه لم ينجُ أحياناً ولاحقاً من الشطحات المثالية فلسفياً إضافةً إلى النسبويّة. النص تلخيصٌ لمقاطع مختارة من الصفحات )55–70) من مقدّمة كتابه «السببية والصدفة في الفيزياء الحديثة» (1957) Causality and Chance in Modern Physics.
ولكي نفهم أكثر ما الذي يحاول بوهم أن يخبرنا به ، ينبغي أن نمسك "علمياً وفلسفياً بالمفاصل الخفية التي يتحرك من خلالها هذا المبدأ ، و"بعيداً عن ((تأويلية مجموعة معينة)) للأطر الرياضية ، المحددة بمسلمات مسبقة غير مثبتة" ، ما هي العناصر الفيزيائية-الفلسفية الأساسية لمبدأ الارتياب ( بالأصح : اللاتعيين ) :
أ. ما هي الفيزياء :
دراسة (الظواهر) المحلية ، لاشتقاق القوانين التي تحدد سير الأحداث فيها كما تبدو لعدة مراقبين يرصدونها من زاوية الاقتران الزمكاني ، ثمّ يقومون بتفسير نتائج مقارنات القرائن الحدثية ، مِثلُ هذه القوانين ، ليست وظيفتها تعليل أي شيء فلسفياً ( من حيثُ الوجود المعقول له ) بل هي نطاق مُحدد من المعقولات الافتراضية ، يشرح "الحركة" المولدة للحدثية التي يتم رصد آثارها ضمن الفضاء الزمكاني ، الأحداث الزمنية التي يتم رصدها ضمن إدراكك والتي تتضمن شروحات الفيزيائيين لها ، ليس أكثر من ذلك ، هذا الشرح ، شرحٌ افتراضي ( بالكامل ) ، ليس بالضرورة أن يكون غير صحيح أو غير مجدي ، المسألة فقط أنه ، يتعلق بالإحصاءات والاحتمالات في المُقدمات الحسية التي يُبنى عليها ، وب"التأويلات وِفقَ مفاهيم غير محقق بها جيداً" من حيثُ المُقدمات العقلية التي تُعالج تلك المُعطيات الحسية …
ب. ما هي فلسفة العلم في الفيزياء :
فلسفة العلم هي تلك النماذج التي تحتوي على المسلمات والقواعد التي يسير من خلالها منهج البحث العلمي ، ويتحدد من خلالها موضوع العلم ، وهذه "الخوارزميات العلمية" تقسم إلى نوعين : التصورات والأحكام.
التصورات : مُدركاتٌ حسية ومفاهيم عقلية لم تربطها بعدُ بحكم معين
الأحكام : نفسُ تلك الأمور مع ارتباطها بحُكم "الثبُوت"
التصورات والأحكام في الفيزياء الوضعية : جميعها صحيحة ، لكن جميعها مُجملة ولا تحكي أي شيء دقيق ، من المُهم ذكره أيضاً ، أن السببية والحتمية ، والماهوية ، ومعقولات المنطق ، ومعقول "الوجود المُطلق(الذي لا يُمكنك إثبات المحمول على الموضوع\الحُكم على المحكوم دون وساطته فهو ثبوت الشيء)" كُلها ، عناصرُ يتمُ عدم الاكتراثِ بها ، ولكن لابُد منها ليكون هناك "معنىً" للمعطيات والمدلولات ، ضمن علم الفيزياء وأي علمٍ آخر. ولم يتم التحدث بعد عن العلم الذاتي الذي يرجع إليه كل البنيان الفلسفي والمعرفي البشري.
ابتداءً من المفاهيم الطبيعية كالكُتلة والطاقة والحجم والطول ، والمعقولات الطبيعية المُرَكبة كالحقول والمجالات والقوانين والمعادلات ، مروراً بالمفاهيم الرياضية الكمية والهندسية ، عبوراً إلى المفاهيم الكُلّية المنطقية والفلسفية ، مثل السببية والحتمية ، واللاسببية واللاحتمية ، الإمكان والفعل ، التجريد والتقييد ، المُركب والبسيط ، مقولة الكيف ومقولة الكم وموقولات الزمان والمكان والقوة والفعل والوجوب والإمكان والامتناع ، مبادئ الهُوية ، مبادئ المعرفة ومنهاجُها ... كُلُّ ذلك مستخدم بكُلّ خطوة في أي نسق علمي ، أو حتى بحثٍ علمي ، نعم إنّه يتعرض للتشكيك ، نعم إنّه ليس محسوساً ضمن الواقع المحلي ، نعم إنّه ليس مادة وليس قابلاً للاختزال ضمن المادة ، ولكنّه "موجود" بتأثيره على المادة ، إنه "قائمٌ" على الكون ، هذا النظامُ التجريدي المعقول ، لا يخرج عن حيطته شيءٌ ضمن الكون المنظور ، إلا وخرج عن وجوده أيضاً ، ليس فقط في العرفة بل في التأثير الواقعي أيضاً ... هذه كُلُّها تستخدمُها الفيزياء دون تعليمها للفيزيائيين.
من جِهة أخرى ، ثبوت وجود الكائن الفيزيائي ، وخبرية وجوده نفسها ، وثبوت نسب أي صفة رياضية أو فيزيائية نحوه ... الثبوت ، التوصيف ، والتأويل ، والإدراك ، هذه أدوات الفيزيائي ، بل الكائن الحي ، لبناء معرفة بأي شيء ، وأي معرفة سيبنيها سوف تتحقق ضمن الاحتمالات التي يَسمَح له بها ، ذلك البُنيانُ العقلي ، وخارجَهُ لا وجود للمعرفة أصلاً ... والفيزياء بصيغتها المادية المتعصبة ، صادقت على ذلك كُلّه ولكنّها ردت لكون انبعاثاً من المادة.
التصور الفيزيائي للعالم ، ليس هو الواقع الفيزيائي الذي يتمُّ تصوره ، الواقِعُ الفيزيائي موضوعٌ للإدراك ، أما التصور والنمذجة فهي فعلٌ عقلي يتم من خلاله معالجة موضوع الإدراك وحوسبته ، عِلمُ الفيزياء التجريبية يستنِدُ إلى مُقدمات مسبقة لبناء مثلِ هذا التصور ، لأنّ الواقع الفيزيائي لا يحتوي أيّ مُقدّمات من أي نوع ، بل أحداثاً متوالية لا تُخبر بأي أحكام ولا تعطي أي تفسيرات.
يوجد أيضاً ، خوارزميات خاصة ب"منهج البحث العلمي" في الفيزياء ، تؤثر على النتائج النهائية التي يصل لها الفيزيائي ، بل "تفرُضُها فرضاً عليه" تماماً كما تفرض قوانين بلدك عليك ما لا تريده ، ولكن الفيزيائي يُهمل هذا الموضوع ويتشربه لاشعورياً وبالتدريج ، لا حاجة مثلاً لربط "علة النتيجة" ضمن التجرُبة ، بكونها مادية وموضوعية ، بالنسبة للنتيجة فلا بأس ، من أجل دقة القياس واعتبارات معينة ، لكن بالنسبة ل"التعليل" !! هذه مُصادرة ليس لها أي تبرير ابستمولوجي - سوى أنك ترغبُ بذلك لدوافع لاشعورية خفية - خاصة وأنك حتى الآن ، لا تعرف "بالضبط" ما الذي تقصِدهُ ب"المادة" فكيف تُعممها على كل ما هو موجود ( وليس فقط كل ما هو فيزيائي).
ج. ما هي ميكانيكا الكم :
ماذا نقصد عندما نقول "ميكانيك الكم" ؟ نقصد أن الالكترون مثلاً هو "كم لحقل فيزيائي" أو لمستوىً معين مميز من هذا الحقل ، فالالكترون هو أصغر وحدة للكهرباء التي يمكنها إحداث تأثير موضوعي ( بحيث يتكمم الحقل الكهربائي نسبياً عندما ندخل لعوالم أصغر من الالكترون ، أما البروتون فلا يمكن التعامل مباشرة مع شحنته الكهربائية ). ولكن ذلك لا يشكل كامل القصة ! إنه يخبرنا عن "الكم" وليس عن "ميكانيكا الكم" ، وميكانيكا في اللغة الكلاسيكية هي مصطلح يشير للقوانين الحتمية التي تحكم سلوكاً فيزيائياً معيناً ، أما ما يقصد عادة من ميكانيك الكم ، هو "المبادئ ( وليس القوانين ) التي يمكن من خلالها ( توصيف ) السلوك الفيزيائي ( المستنتج بالاستقراء الناقص ) للجسيمات الأولية ( الافتراضية ) وما دونها.
والفرق بين المبدأ النظري والقانون ، هو أن الأخير يستوجب وجود "حتمية أو سببية" بينما الأول لا يستلزم ذلك ( وفقاً لبعض الرؤى الفلسفية ) ، وإني لأستميحهم عذراً لأخبرهم أن هذا نوع آخر من اللبس قد وقعوا فيه ، لأن المبدأ النظري هو "كلي" أشمل من القانون ، فيشمل الأشياء المقننة وغير المقننة ، لكن هذا لا يعني أنه "يخرج عن السببية" ، فأنت نفسك عندما تضع تعريفاً كهذا ، فإنك تخضع "الالكترون" وكافة الجسيمات الأولية الأولى إلى "المعقولات الفلسفية" التي تمتد من أول تعريفك إلى آخره ( وأنا أعلم أنك لا تستخدم المصطلحات التي استخدمتها عندما تعرف الكمومية ، إلا أنني قمت بترجمة "نفس تعريفك" للمكامن الفلسفية التي يحتويها ، بغية معالجته بشكل فلسفي وتجريدي ).
إنك "لا تستطيع" أن "تتخيل حتى" وجود الالكترون وسلوكه الارتيابي ، دون الاستعانة بالمعقولات الفلسفية والمنطقية. وهذا يطرح الإشكالية الرئيسية ، وضربة الهلاك الموجهة نحو الفيزياء الحديثة بصيغتها الوضعية ، هذه الإشكالية التي تقول : من يقود من ؟ الجسيمات الأولية أم الكائنات العقلية ؟ فالتوجه العام في الفيزياء الحديثة كثيراً ما يتجرأ على محاكمة "قضايا فلسفية" من خلال "مجرد مقاربات لسلوك الالكترون" ، وحُق لنا أن نسأل : هل امتلك الفيزيائي المؤهلات الكاملة فلسفياً لكي يناقش مثل هذه الأمور ، التي تقع أصلاً في بُعد يسبق الفيزياء بكثير وكثير جداً ، هذا التصرف له تسمية دقيقة في الفلسفة ، إنه : الموقف الطبيعي الساذج.
وبعبارة أخرى فليس من الممكن ل"قانون" أو "مبدأ" جزئي أن يرفع رأسه نحو "مبدأ أكثر كلية" ويقوم بتوبيخه أو تسخيفه أو رفضه ، أو نحو تلك الأمور ، لأنه عندما يقوم بذلك ، فهو يرفض ويوبخ ويسخف نفسه في المقام الأول ، لأن ذلك المبدأ الأكثر كلية ، متغلغل ومتناشر في كل ذريرة من ذريرات المبدأ الجزئي ، بحيث أن حياة هذا الجزئي ، تعتمد اعتماداً ضرورياً وحتمياً على حياة ذلك الكلي. لا يمكنك أن تقوم بالادعاء بأن الالكترونات "لا تسري عليها الرياضيات الإحصائية المتقدمة" بحجة أن "الثور" لا يمكن فهم سلوكه أو جسمه بذلك النوع من الرياضيات ! وكذلك لا يمكن إسقاط الرياضيات البحتة بمحاكمتها فيزيائياً والادعاء بأنه ليس هناك شيء يشبهها في العالم الزمكاني الذي نعرفه ، وعلى نفس المبدأ تسير الأمور مع مبدأ "الارتياب" … ليس من الممكن ل"مجرد مقاربة" للسلوك الذري أن "تلغي مبدأً أكثر كلية وشمولية" والذي ، هي بالأصل "كمقاربة أو كنظرية ، أو حتى كذاتية موجودة فعلياً" تعتمد عليه لكي تخرج إلى النور. حتى ولو خرجت هذه الأفكار من "أكبر الأفواه على الإطلاق" ، فهذا لا ينفي كونها مجرد مغالطة ناشئة عن "التقصير في دراسة الفلسفة!!" ، وأي فيلسوف يحترم نفسه لا يمكن أن يقع في مثل هذا المستنقع ، إلا إذا كان "متحاملاً ومتحيزاً" أو "خائفاً من سحب شاهدته" ، أو ببساطة "ساعياً لأمر معين" …
"ولأكون صريحة معك ، هذا النوع من ميكانيكا الكم ، لا يمكن أن لا يؤذيك بشكل أو بآخر" …
د. ما هو أهم مبدأ في الفيزياء على الإطلاق ، وكيف نرى الالكترون من خلاله :
وقد اخترتُ هذا الجسيم بالذات لأن سلوكه هو الأكثر سلاسة وأُلفة للفهم بين جميع الناس على مختلف الثقافات ، ورغم ذلك ، "كاذبٌ" من ادعى أنه يعلم "ماهية الالكترون" من خلال البحوث العلمية ، وكل ما توفره الفيزياء الحديثة هو "توصيف" لبعض السلوكيات التي تم التمكن من رصدها -جُزئياً وشبحياً- للالكترون ، وأما تلك الصور التوضيحية والعروض التقديمية التي تراها في الكتب الفيزيائية والجامعية والمحاضرات والفيديوهات ، فهي فقط محاولة لجعلك تفهم الأمر عبر محاكاته بصرياً ، وحقيقة فليس بالضرورة عندما نتحدث عن "كتلة الالكترون" أو "شحنته" أو "عزمه" أو "حركته" أن تتخيل شيئاً له أبعاد مكانية ويتحرك ضمن الزمان بسرعة محددة ( والتي مهما كانت عالية ستبقى محددة ) !! ربما ( وهي نظرية تلقى تأييداً متزايداً ) أن الجسيمات الأولية هي "تأثيرات برمجية" أكثر من كونها بنىً فيزيائية ذات كيان مادي … لا ليس فقط ذلك ، بل حتى ما تظنه أنه "تعريف نهائي" للكتلة أو للطاقة ، أو للجسيم أو للذرة ، هو فقط "توصيف لظاهرة موضوعية تتكرر بشكل متواتر وفق علاقات معينة مع ظواهر أخرى" والظاهرة ، ليست شيئاً بحد ذاته ، بل مجرد "عَرَضٍ" للشيء ، بحيث ليس هناك مانع أن تكون هي بدورها نوعاً من "البرمجة العميقة أيضاً"… أحد تلك الاتجاهات هو نظرية "المُنظِّم المستتر" ( الترجمة الصحيحة لنظرية النظام الضمني ) …
مبدأ الدّوال الفيزيائية : فهم المعنى العميق لنظرية "الدالة الرياضية (التابع)" :
هي شيء ( أكثر تجريداً ) من الرياضيات ، لكنها ( تحكم الرياضيات ) وتتفاعل معها ، ولعلك إن عرفت هذا السر ، سيسهل عليك فهم سبب موقفي من المعرفة الفيزيائية وكوني أتبنى ( منهجاً فينومونولوجياً وعرفانياً وسحرياً ) لدراسة الظواهر والنظريات الفيزيائية ، ولا أعتمد على الرياضيات وحدها في الوصول لإجابات عن الأسئلة الكبرى التي تقع خارج نطاق الرياضيات أصلاً …
فالدالة الرياضية ، هي شرحٌ بلُغة الرياضيات ، لمفاهيم عقلية مُجردة "كُتلة\طاقة\جذب" ، لها مصاديقُ فيزيائية "هذه الكُتلة" وهي كائنات حدثية محلية ، وهذه المصاديق ، بسبب تعينها في نطاقٍ محلي ، تتقيد ضمن "أرقام" ما هي إلا "أنساب" لمصاديقَ أُخرى ، زمنُ بلانك ليس 10^-44 من الثانية !! من أين جئتَ بالثانية أصلاً ؟ هل استطعتَ أن تُمسِك بواحدة بشكل مُطلق ، لتحولها لقياسٍ مُطلق ؟ الثانية أصلاً ( وحسب النسبية ) يستحيل أن تكون نفسها ضمن قياسين مختلفين محلياً ، أنت قد لا تُحس بذلك ، وربما حتى أجهزة قياسك المحدودة مهما بلغت ، لن تحس بذلك - ليس قبل بضعة عقود أخرى - ، ولكن "الكون" يحس بذلك ويفهمه جيداً ، ويُفَهمك إياه.
"إشكالية الضباطة" ليس فقط بسبب نسبية الزمكان ، كل المعايير والوحدات الأولية ، نسبية أيضاً ، المتر ، السنتيمتر ، الغرام ، المل ، جميعها ، وبلا استثناء ، بُنيت على "نماذج تقريبية" ، وكل ما بني على الظن فهو ظنٌ مثله ، ولربما يكون الاختلاف في كل مرة 0.0000001 أو أقل ، ولكن ومع تكرار الاختلاف ، وزيادة التناهي في الدقة المطلوبة للقياس ، دائماً ، ستجد علامة ( يُقارب ) عوضاً عن (يُساوي ) ، وستجدُ دائماً دخول الإحصاء في مضمار الفيزياء ، وسترى ( أو تُدرِك ) أن معيارك الأصلي كان نسبياً تماماً ، وفي كل مرة قمتَ بمضاعفته سلباً أو إيجاباً ، تزدادُ النسبية ، فهذه المُضاعفات ، تدخُل في محليات أخرى تخضع لتآثرات أخرى ، ربما لا تحس بذلك ، ولكن ، إذا صنعت وحدة قياس بعرض عُملة بلدك المعدنية ، وضاعفتها عشرة مرات ، فالعرض الجديد ، ليس في الواقع 10 أضعاف طباقاً من العرض المعياري ، ومع تكرار الاختلاف حتى تصل للمرصودات ذات الدقة المُتناهية ، يتلاشى تماماً المعيارُ الذي استخدمته في البداية.
وحدات القياس ، تأويلات متواضع عليها ، الكون ، ليس فيه ثانية أصلاً ، وليس فيه غرام ومتر ، بل فيه "معاني" ولأنك لا تصلُ للمعاني ، تستخدمُ وحدات القياس من أنساب المصاديق ( الغير ثبوتة ) لمقاربتها. فلا تغرنك تلك المُعادلات الأنيقة ، التي تملأ عشرة سبورات متجاورة ، لتشرح نظرية M-Theory ، هذه كلها ليست إلا ، نوعاً من "التأويل".
الدالة الرياضية ضمن علم الفيزياء ، لا تتحدث عن الرياضيات ، بل عن "الكميات الفيزيائية المُقيدة بالرياضيات- التي قيدتَها بالرياضيات المُستندة على وحدات قياسك الغير ضبوطة" ، وحدات قياسك تأويلات وضعية ، تقيس بها "مفاهيم شبحية" ضمن نطاق أرصاد محلي "بناءً على قدراتك التجريبية المحدودة" ، وبعدها ، تستخلص (لا تستنتج) أحكاماً لتلك "المفاهيم الشبحية" محولاً إياها لدالة رياضية فيزيائية وهذه الأحكام بالطبع مقيدة بفلسفة المعرفة خاصتك وبقدرات عقلك التجريدية ، وبعدها تنطلِقُ في رحلة لبناء نظريات جديدة عليها - هذا إن كنتَ تبني مثل تلك النظريات - حتى تصل ل"منظومة تركيبية شبحية وضعية\استخلاصية شديدة التعقيد والإبهام" لتصف كيف توحد تلك المجالات والحقول ( التي لم تَدري كُنهها أصلاً-فقط وصفت الإجراء الرياضي المزعوم لها والذي لا تعلم شيئاً عن ما يعنيه حقيقة ) ، وأخيراً ، لتربطها بتأويليتك حول الأسئلة الكُبرى للعالم … مِثلُ هذه النظرية ، أصلاً ، تشرحُ أسيار الحدثيات ضمن النطاقات المحلية ، ولا تعدو عن ذلك قيد أَنمُلة ، وإذا كُنت ترى - ورُأيُكَ الحق - أنها تستلزمُ "أزلية العالم" أو "اللاحتمية والارتياب والفوضى" ، فهذا نوعٌ من التنمطُق والتفلسُف الذي يستخم الجدال الظني ، وليس من الدراسة العلمية الجادة للظاهرة الفيزيائية ، سواءً الوجودية أو الإدراكية ( إن صح التعبير ).
مرجع مقالة ديفد بوهم المترجمة : نقد ميتافيزياء اللايقين
فالدالة الرياضية ، هي شرحٌ بلُغة الرياضيات ، لمفاهيم عقلية مُجردة "كُتلة\طاقة\جذب" ، لها مصاديقُ فيزيائية "هذه الكُتلة" وهي كائنات حدثية محلية ، وهذه المصاديق ، بسبب تعينها في نطاقٍ محلي ، تتقيد ضمن "أرقام" ما هي إلا "أنساب" لمصاديقَ أُخرى ، زمنُ بلانك ليس 10^-44 من الثانية !! من أين جئتَ بالثانية أصلاً ؟ هل استطعتَ أن تُمسِك بواحدة بشكل مُطلق ، لتحولها لقياسٍ مُطلق ؟ الثانية أصلاً ( وحسب النسبية ) يستحيل أن تكون نفسها ضمن قياسين مختلفين محلياً ، أنت قد لا تُحس بذلك ، وربما حتى أجهزة قياسك المحدودة مهما بلغت ، لن تحس بذلك - ليس قبل بضعة عقود أخرى - ، ولكن "الكون" يحس بذلك ويفهمه جيداً ، ويُفَهمك إياه.
"إشكالية الضباطة" ليس فقط بسبب نسبية الزمكان ، كل المعايير والوحدات الأولية ، نسبية أيضاً ، المتر ، السنتيمتر ، الغرام ، المل ، جميعها ، وبلا استثناء ، بُنيت على "نماذج تقريبية" ، وكل ما بني على الظن فهو ظنٌ مثله ، ولربما يكون الاختلاف في كل مرة 0.0000001 أو أقل ، ولكن ومع تكرار الاختلاف ، وزيادة التناهي في الدقة المطلوبة للقياس ، دائماً ، ستجد علامة ( يُقارب ) عوضاً عن (يُساوي ) ، وستجدُ دائماً دخول الإحصاء في مضمار الفيزياء ، وسترى ( أو تُدرِك ) أن معيارك الأصلي كان نسبياً تماماً ، وفي كل مرة قمتَ بمضاعفته سلباً أو إيجاباً ، تزدادُ النسبية ، فهذه المُضاعفات ، تدخُل في محليات أخرى تخضع لتآثرات أخرى ، ربما لا تحس بذلك ، ولكن ، إذا صنعت وحدة قياس بعرض عُملة بلدك المعدنية ، وضاعفتها عشرة مرات ، فالعرض الجديد ، ليس في الواقع 10 أضعاف طباقاً من العرض المعياري ، ومع تكرار الاختلاف حتى تصل للمرصودات ذات الدقة المُتناهية ، يتلاشى تماماً المعيارُ الذي استخدمته في البداية.
وحدات القياس ، تأويلات متواضع عليها ، الكون ، ليس فيه ثانية أصلاً ، وليس فيه غرام ومتر ، بل فيه "معاني" ولأنك لا تصلُ للمعاني ، تستخدمُ وحدات القياس من أنساب المصاديق ( الغير ثبوتة ) لمقاربتها. فلا تغرنك تلك المُعادلات الأنيقة ، التي تملأ عشرة سبورات متجاورة ، لتشرح نظرية M-Theory ، هذه كلها ليست إلا ، نوعاً من "التأويل".
الدالة الرياضية ضمن علم الفيزياء ، لا تتحدث عن الرياضيات ، بل عن "الكميات الفيزيائية المُقيدة بالرياضيات- التي قيدتَها بالرياضيات المُستندة على وحدات قياسك الغير ضبوطة" ، وحدات قياسك تأويلات وضعية ، تقيس بها "مفاهيم شبحية" ضمن نطاق أرصاد محلي "بناءً على قدراتك التجريبية المحدودة" ، وبعدها ، تستخلص (لا تستنتج) أحكاماً لتلك "المفاهيم الشبحية" محولاً إياها لدالة رياضية فيزيائية وهذه الأحكام بالطبع مقيدة بفلسفة المعرفة خاصتك وبقدرات عقلك التجريدية ، وبعدها تنطلِقُ في رحلة لبناء نظريات جديدة عليها - هذا إن كنتَ تبني مثل تلك النظريات - حتى تصل ل"منظومة تركيبية شبحية وضعية\استخلاصية شديدة التعقيد والإبهام" لتصف كيف توحد تلك المجالات والحقول ( التي لم تَدري كُنهها أصلاً-فقط وصفت الإجراء الرياضي المزعوم لها والذي لا تعلم شيئاً عن ما يعنيه حقيقة ) ، وأخيراً ، لتربطها بتأويليتك حول الأسئلة الكُبرى للعالم … مِثلُ هذه النظرية ، أصلاً ، تشرحُ أسيار الحدثيات ضمن النطاقات المحلية ، ولا تعدو عن ذلك قيد أَنمُلة ، وإذا كُنت ترى - ورُأيُكَ الحق - أنها تستلزمُ "أزلية العالم" أو "اللاحتمية والارتياب والفوضى" ، فهذا نوعٌ من التنمطُق والتفلسُف الذي يستخم الجدال الظني ، وليس من الدراسة العلمية الجادة للظاهرة الفيزيائية ، سواءً الوجودية أو الإدراكية ( إن صح التعبير ).
مرجع مقالة ديفد بوهم المترجمة : نقد ميتافيزياء اللايقين
التعديل الأخير: