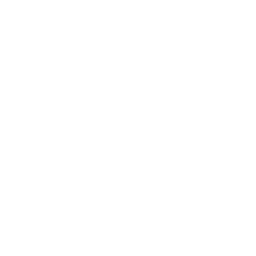Ile
مريد 1
- المشاركات
- 114
- مستوى التفاعل
- 3,725
بقلم مارشال غوفيندان
في سبعينات القرن العشرين، تناول كتاب من الكتب أكثر رواجا عنوانه ’’أنا على ما يرام، أنت على ما يرام‘‘، شأنه شأن الكثير من الكتب التي أخذت تصدر منذ ذلك الحين، العلاقات البشرية وكيفية الاستفادة منها إلى أقصى حد. ويعبر عنوان الكتاب عما يفعله معظمنا طول الوقت: إصدار الأحكام على الآخرين. ومما يؤسف له أن معظم أحكامنا ليست ’’على ما يرام‘‘، بل تشكل بالأحرى آراء تؤذي الآخرين وتؤذينا. ومن ثم تصبح العلاقات بين الناس مصدرا لانقسام وصراع كبيرين. وفي العقود الماضية، ركز جانب كبير من علم النفس على تحسين علاقاتنا الاجتماعية، وإدارة الصراع، وعلى جعل شخصياتنا مقبولة بقدر أكبر من الناحية الاجتماعية. غير أن دور إصدار الأحكام في علاقاتنا الاجتماعية ليس مفهوما على نطاق واسع.
التعاطف والنفور
أوضحت الدراسات في مجال علم النفس أن معظم الأشخاص يُكوِّنون انطباعات دقيقة إلى حد معقول عن الآخرين في غضون دقائق قليلة. كما لو كان الكائن الإنساني لديه القدرة على أن يجري مسحا سريعا للآخرين ويستوعب، ولو حدسا، كثيرا من السمات الصحيحة. غير أن هذه الانطباعات تستثير أحكاما تصطبغ عادة بميول الفرد ومشاعره. فقد أظهرت مثلا دراسة حديثة عن المقابلات التي تجرى لتعيين الموظفين أن المرشحين الذين كانوا متعاطفين مع من أجروا لهم المقابلات كانوا هم الذين يقع عليهم الاختيار عادة للوظائف المطلوبة حتى وإن لم تكن إجاباتهم ومؤهلاتهم كافية في كثير من الأحيان، في حين أن المرشحين الذين كانوا يشعرون بشئ من النفور ممن أجروا لهم المقابلات لم يحالفهم النجاح حتى وإن كانت إجاباتهم ومؤهلاتهم جيدة على نحو استثنائي. ويبين هذا أن من أجروا المقابلات كونوا عن المرشحين أحكاما تستند إلى عوامل ذاتية، تشمل المشاعر، بل والحدس، أكثر مما تستند إلى عوامل موضوعية. ويوضح ذلك أن لدينا القدرة على استشعار الأحكام التي يضمرها الآخرون عنا.
ما المقصود بالأحكام:
الأحكام آراء تُكوَّن استنادا إلى تجارب محدودة، بل وإلى الإشاعات أحيانا. فهي لا تستند إلى وقائع، وتنحو إلى التيبس في شكل حقيقة ثابتة حتى قبل تقييم الوقائع المعنية. بل والأسوأ أنها تستند في كثير من الأحيان إلى التعصب والخوف والتخيل. أفلا يشعر البعض مثلا برد فعل فوري عندما يرون رجلا وامرأة من لونين مختلفين يتحدثان حديثا حميما.
الحكم السديد:
إن التحدي المطروح علينا ليس تجنب إصدار الأحكام بقدر ما هو تكوين ’’الحكم السديد‘‘. و’’الحكم السليم‘‘ صفة تحظى بإعجاب كبير، غير أن أصول الحكم السديد ليست مفهومة بصورة جيدة. فهو نتيجة تفكير وتدبر، وهو مشبع بالحس السليم، إن لم يكن بالحكمة. وهو متحرر من الانفعال والتعصب. كما أنه يقوم على حصافة الفكر بسعيه إلى الموازنة بين كل العوامل ذات الصلة. وهو ’’سديد‘‘ لأنه ينهض بكل المعنيين به. فهو يرفع المعنويات ويجلب البهجة، ولا يتسبب أبدا في إلحاق الأذى. فقد يقول صديق شيئا صادقا لصديقه ولكن الأخير قد لا يكون مستعدا لسماعه. وعندئذ يرفضه وينشأ صراع، بل وقد يفقدان صداقتهما. ومن ثم فإن ’’الحكم السديد‘‘ يعبر عن نفسه بطريقة تسعى دوما إلى تخليص كل المعنيين من المعاناة، بل وإلى تحقيق البهجة. وهو نتيجة ذهن وصل إلى حقيقة وضع ما، من خلال الحدس أو التجربة أو المهارات التحليلية القوية. إن الحكم السديد هو في كثير من الأحيان ثمرة التجارب، ولذا يعتبر كبار السن متحليين عادة بقدرة على الحكم السديد أكثر من الشباب الذين تكون أحكامهم متشربة في كثير من الأحيان بالإثارة الانفعالية أو بروح التمرد. وعلاوة على ذلك، ينسب ’’الحكم السديد‘‘ إلى الحكماء الذين يبدو أن لديهم صلة خاصة بحقيقة الأشياء، وقدرة حدسية على لمس أصل الوجود، ذلك الذي يبقى بعد فناء كل شئ.
لماذا يعد إصدار الأحكام مؤذيا؟
يعد إصدار الأحكام مؤذيا بوجه عام للأسباب التالية. أولا، إنه يعبر عن الحالة الذهنية للشخص الذي يصدرها. وقد أوضحت الدراسات النفسية أن الشخص العادي ينفق أكثر من ثلثي وقته في حالة ذهنية أو انفعالية سلبية. فمشاعر الاكتئاب والحزن والخوف والعجلة والغرور تسيطر على الشخص العادي. وإلى أن يتعلم المرء كيف يتحكم في هذه الحالات، يعبر ما يصدره من أحكام عادة عن هذه الحالة الخاصة به. أي أننا نسقط على الآخرين ما نشعر به نحن. ونفترض أنهم يشعرون بما نشعر به، لأن إدراكنا يكون متأثرا بحالتنا الداخلية. إن أحكامنا تؤذي الآخرين لأننا نسقط عليهم رد فعل سلبيا، إن لم يكن رد فعل خاطئا.
وثانيا، تسبب الأحكام الأذى لأنها تفترض أن الحالة المعنية تظل ساكنة. فعندما نصدر حكما عن شخص آخر، يكون هناك افتراض ضمني بأن الشخص الذي نحكم عليه لن يتغير على الأرجح. ومع أن الطبيعة البشرية تعد ثابتة عموما إلا أنها تتغير في كثير من الأحيان. فالناس يمرون بأيام سيئة ومآس وفورات انفعالية. ويكون سلوك عندئذ غير معتاد ولا يعبر عن شخصيتهم الكامنة خلف السطح. ولذا فإن إصدار أحكام عن أناس يمرون بأوقات عصيبة أمر خاطئ. فالشباب يتجاوزون سلوكهم غير الناضج مع تقدمهم في العمر. وأقوياء الإرادة يتغلبون على الميول السلوكية السيئة ويصلحون من أنفسهم. ومن ثم فإن إصدار أحكام ثابتة لا يفسح مجالا للنمو، وللتغير في اتجاه إيجابي، ولذا تتسبب في إلحاق الأذى. فالأحكام تخلط عادة بين الأشخاص وسلوكهم. ويحتاج المرء إلى التحلي بالحكمة لإدراك الفرق. فبالحكمة يدرك المرء أنه ليس جسده ولا ذهنه ولا شخصيته، فتلك الأمور أشبه بالملابس التي نستطيع تغييرها أو التي قد نحتفظ بها بحكم العادة. وبالحكمة يدرك المرء أن هويته الحقيقية هي وعي خالص، هي الروح، الرائي أو الشاهد، وأنه لديه القوة لتغيير السلوك المعتاد بممارسة إرادته.
وثالثا والأهم، تسبب الأحكام الأذى لأنها تعزز الصفة المدانة، لا في الشخص المحكوم عليه فحسب، بل أيضا، وهذا أكثر دلالة، في الشخص الذي يُصدر الحكم. فعندما نصدر حكما عن شخص آخر، معتقدين أن ’’ذلك الشخص جشع‘‘، فإننا نستغرق من الناحية الفعلية في صفة الجشع، ولذا نعززها في أنفسنا. وهذا أمر يذكر بالقلق الذي يمكن تعريفه بأنه ’’التفكير فيما لا ترغب فيه‘‘، فالحكم على الآخرين هو التفكير فيما لا ترغب فيه في نفسك.
ويقول ’باتنغالي‘، وهو أحد آباء اليوغا الكلاسيكية وكان معاصرا للمسيح: ’’عن طريق إنماء مواقف الصداقة تجاه السعداء، والمحبة تجاه التعساء، والابتهاج تجاه الفضلاء، والاتزان تجاه غير الفضلاء، يعود الوعي إلى الهدوء الذي لا يزعجه شئ‘‘ (’اليوغا سوترا‘، الفصل الأول، القول الثالث والثلاثون). وعندما لا نفعل ذلك، ما الذي يحدث؟ يصبح ذهننا قلقا وحافلا بالأحكام والمشاعر السيئة والضغينة والغضب والاشمئزاز. وبالتالي، نفقد الشرط الأساسي لتحقيق الله: أي الهدوء والسلام والنقاء الداخلي والبراءة. إن العالم في داخلنا. ولتغيير العالم من مكان ملئ بالشر إلى ’’جنة السموات‘‘ علينا أن نغير أفكارنا. تغافل إذن عن نواقص الآخرين. ولا تستغرق في نقاط ضعفهم. فإن ذلك يقوي هذه النقاط.
’أهيمسا‘، اللاأذى، دواء إصدار الأحكام
كيف يمكن تجنب إصدار الأحكام التي تؤذي الآخرين؟ يخبرنا الحكماء بأننا نحتاج إلى إنماء موقف اللاأذى، الذي يطلق عليه في الهند اسم ’أهيمسا‘. ويشمل اللاأذى، عدم إلحاق الأذى بالأفكار أو بالكلمات أو بالأفعال. وهو يستند إلى الاعتراف بأن هناك عواقب أو ’كارما‘ تنتج حتى من الأفكار. فالأفكار، كثيرا ما تكرر بحكم العادة، والعادة تُوجِّه بعد ذلك حياة الفرد. وإذا كانت العادة تنطوي على رغبة ولم يتسن إشباع هذه الرغبة، تخبط المرء في وهدة الإحباط لأنه لا يدرك أن مصدر السعادة في الحياة وهو الفرحة الداخلية الدائمة للروح.
لقد قال المسيح عندما وضعوه على الصليب: ’’يا أبتاه، أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون‘‘، واصفا من حكموا عليه هذا الحكم القاسي. فبدلا من أن يكون غاضبا عليهم، أو مستغرقا في آلامه، كان أكثر انشغالا بالعواقب ’الكارمية‘ لأفعال مضطهديه. إذ كان يعرف فيما يبدو أن العواقب ستكون قاسية وفقا لقانون ’الكارما‘، ولم يُرِد لهم أن يعانوا بسببه. ولذا دعا أباه أن يغفر لهم. إن الغفران ينبع من الحب لا من إصدار الأحكام. لقد كان ذلك نموذجا أسمى لما أوصى به ’باتنغالي‘ في ’اليوغا سوترا‘: ’’عندما تكون ممتلئا بالمشاعر السلبية، طور المشاعر المعاكسة‘‘. كما أتاح الغفران للمسيح أن يجد السلام، وأن يتحرر من آثار الغضب المدمرة.
إن مباركة الآخرين، ومحبة الآخرين، هو دوما بديل أفضل من إصدار الأحكام عليهم. إن أفكارنا ودعواتنا لها تأثير فعلي على الآخرين، ونستطيع أن نحقق فرقا في حياتهم بالأفكار والدعوات الطيبة. وعلى المستوى الخفي الباطن، تكون للأفكار حياة خاصة بها. فعندما نفكر في الآخرين، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ننتج صورا من الأفكار تلتصق بهؤلاء الأفراد وتؤثر على سلوكهم وتجاربهم. ومثال ذلك، أن امرأة اكتشفت أن زوجها يخونها بعد زواجهما ببضعة أسابيع، فدعت عليه بالموت. وبعد عدة أيام، مات زوجها في حادث مرور فصل فيه رأسه عن جسده. ووقعت العروس الشابة نهب مشاعر الذنب إلى درجة أنها ظلت تتخيل طوال عام كامل أنه ما زال يعيش معها، فكانت تعده له وجباته وتقدمها له كما لو كان حيا، إلى أن نجحت أسرتها في إقناعها بأن عليها أن تلتمس مشورة نفسية.
وقد أتاحت بحوث أجريت في جامعة دوك بالولايات المتحدة التحقق من أن الصلاة تعد فعالة في مساعدة المرضى على التعافي من أمراضهم، وأحيانا بشكل معجز. ففي معظم الحالات، يتقلص الوقت اللازم للنقاهة بقدر كبير عندما يصلي الآخرون من أجل شفائك. وعلى مستوى علوم الباطن، يُولِّد الدعاء أشكالا قوية من الأفكار يمكن أن تساعد الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك أن امرأة اصيبت إصابة خطيرة في حادث مرور كانت قد لاحظت بشكل عابر أثناء إصابتها أن شخصا غريبا عنها تماما يدعو لها بالسلامة، وقد تعرفت فيما بعد على هذا الشخص عندما زارها في المستشفي للاطمئنان عليها. وقالت السيدة إن دعاءه هو الذي أنقذ حياتها. ولذا يجب، كمسألة روتينية، أن نبارك الآخرين وأن ندعو لهم، بشكل صامت ودون إعلان، متى رأينا شخصا يعاني بشكل أو بآخر. إن لدينا جميعا فرصا كثيرة لنفعل ذلك. فمثلا ونحن نقود سياراتنا، عندما يقطع علينا شخص ما الطريق، أو عندما نبصر مارا حزينا أو مضطربا، نستطيع أن نقول ’’فليبارك الله هذا الشخص‘‘. أو ’’فليساعد الله هذا الشخص على العثور على السلام‘‘، أو على ’’أن يبطئ سرعته‘‘ أو ’’أن يجد السعادة‘‘. ونستطيع أن نفرح مع الآخرين في حظوظهم الحسنة بدلا من الشعور بالحسد منهم ولنقول: ’’فليبارك الله هذا الشخص. ولتتوالى عليه نعم الله، وليتقاسم هذه النعم مع الآخرين‘‘.
الحكم النهائي أم الغفران؟ من أقوال وأمثال المسيح
قال المسيح: ’’بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم‘‘ (متى 7: 1-2). كان المسيح يتحدى القاعدة الدينية السائدة في ذلك الوقت. فاليهودية كانت دينا تشريعيا. وكان الله هو المشرع، وأعطى موسى الوصايا العشر على جبل سيناء. وكان الله هو الحَكَم النهائي، وكان يُعتقد أنه يدين الذين يخالفون قوانينه، ويثيب من يحترمونها. وكان هذا تقدما بالقياس إلى أديان أخرى مثل دين الكنعانيين الذين كانوا يعبدون صنما على شكل بقرة ذهبية. والأديان البدائية يحركها الخوف، وخاصة الخوف من الموت أو الألم. ولذا يحاول الرجل البدائي أن يهدئ، بتقديم القرابين، ما كان يعتبره مصادر فوق طبيعية للأحداث والظواهر تهدد حياته. وفي وقت لاحق، عندما نظم الناس أنفسهم في مجتمعات، وضعت المجتمعات قوانين لتجنب أن يُلحق الناس الأذى ببعضهم بعضا، ولتنظيم السلوك البشري بأعراف اجتماعية. ولما كانت هذه القوانين تحتاج إلى سلطة نهائية، عمد الحكام، أي الملوك والزعماء عامة، إلى نسبة سلطتهم إلى الله. ومع ذلك الناس كانوا يرتكبون جرائم القتل دون أن يحاكموا، وكانت الأشياء السيئة تحدث للأخيار، وبغية الحفاظ على الإحساس بالعدل، خلق الإنسان صورة الله العادل، الحاكم النهائي، الذي يعاقب الشرير ويثيب الخير. فنحن نجد مثلا في العهد القديم كثيرا من الأنبياء يتحدثون عن ’’يوم الحساب‘‘، وفي الهند نجد مفهوم ’’برارابها كارما‘‘ الذي تكون بمقتضاه لأعمال المرء في حياته عواقب في حياته التالية. وعليه، فإن الناس في هذه المرحلة من الدين، حاولوا أن يوازنوا سيئاتهم، أو ’الكارما‘ السيئة، بأشياء تكفر عن ذنوبهم. ووسائل ذلك يمكن أن تكون بسيطة مثل التوبة وإنكار الذات الطوعي، أو قد تكون، كما في مسيحية العصور الوسطى، بتقديم العطايا للكنيسة.
وقال المسيح: ’’ولماذا تنظر للقذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تنظر لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك‘‘ (متى 7: 3-5). أي بعبارة أخرى، ينبغي أن يركز المنتقدون على تصحيح أنفسهم. كما قال: ’’لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل‘‘ (متى 5: 17-20). فما معنى هذا؟ المسيح لم يقل تجاهلوا الشريعة أو الناموس، بل ادركوا أن الله يحبكم. وعمد المسيح مرارا وتكرارا إلى ضرب الأمثال، كمثل الابن الضال (في لوقا 15: 11-32) من أجل توضيح هذه ’’البشارة‘‘. ولأن الله يحبكم تستطيعون أن تحبوا الآخرين. والله الذي يحبكم لا يمكن أن يحكم عليكم باللعنة الأبدية! كانت هذه هي أهم تعاليمه. وحث تلاميذه وأتباعه مرارا على أن يحبوا بعضهم بعضا، وأن ينقوا أنفسهم من التعلق بالماديات، كي يدخلوا ملكوت السموات، الذي قال إنه يحيط بنا من كل جانب، إن تمكنا من إنماء نقاء البصيرة الذي يسمح لنا بأن نبصره (لوقا 17: 20-21). وقال المسيح إننا يجب أن نكون أبرياء مثل الأطفال الصغار إذا أردنا أن ندخل ملكوت السموات. وقال ’’أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم‘‘ (لوقا 6-27). وقال ’’من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا‘‘ (لوقا 6-29). الحب يسبق إذن الشريعة والحكم. قد يكون من حقك أن تطالب بأن تكون ’’العين بالعين‘‘ كما يدعو أنبياء العهد القديم، لكن المهاتما غاندي يقول: ’’قصاص العين بالعين يترك العالم كفيفا في نهاية المطاف‘‘. أي عندما يعمينا إصدار الأحكام والانتقام لا نبصر الحقيقة النهائية وهي أننا جميعا أفراد في أسرة إنسانية واحدة، وأنه من خلال الحب يمكن التغلب على كل الاختلافات.
المهاتما غاندي: رسول اللاعنف المعاصر
قال المهاتما غاندي: ’’كل الذنوب ترتكب سرا. وما أن ندرك أن الله يراقب حتى أفكارنا نكون أحرارا‘‘. أي إن الذنب هو غياب الوعي بحضور الله. ولذا فإن إصدار الأحكام على الآخرين بسبب ذنوبهم، يعمينا عن ذنوبنا نحن! لقد كان غاندي تلميذا عصاميا للحقيقة نجح أخيرا في عام 1947، بعد أربعين عاما من الكفاح، في إجبار الإمبراطورية البريطانية على الرحيل عن الهند بلا عنف، عن طريق إحياء مبدأ ’’الهيمسا‘‘ القديم، أو مبدأ ’’عدم الإيذاء‘‘. وقد ابتكر غاندي أساليبه في تطبيق هذا المبدأ عن طريق دراسة ’الجاينية‘ وأمثال المسيح، اللتين تركزان على عدم الإيذاء. فنساك ’الجاينية‘ يرتدون أقنعة على أفواههم ويكنسون الأرض قبل سيرهم عليها لتجنب قتل حتى الحشرات عن غير قصد. وأصبحت أساليبه القائمة على عدم الإيذاء، أو ’’الهيمسا‘‘، أساس حركة الحقوق المدنية التي استحدثها مارتن لوثر كنغ في الولايات المتحدة في ستينات القرن العشرين، وفي غيرها من الحركات النقابية والاجتماعية الأخرى التي استخدمت المقاومة السلبية والاحتجاجات والمظاهرات اللاعنيفة من أجل توعية الجمهور بقضاياها. وفي الهند، شارك آلاف الرجال والنساء في حركة ’’ساتياغراها‘‘ التي تدعو إلى العيش وفق مبادئ الحقيقة (ساتيا) دون إيذاء الآخرين. وفي المظاهرات الضخمة التي اندلعت ضد الجيش البريطاني الاستعماري، تعرض الآلاف للضرب حتى الموت أو التشويه دون إبداء أدنى قدر من المقاومة. لقد بلغ إصرارهم على إدارة الخد الآخر حدا أجبر البريطانيين أخيرا على التخلي عن حكمهم الاستعماري للهند الذي دام أكثر من 300 عام. وقضى غاندي عقودا داخل السجون البريطانية، صائما لفترات طويلة، كي يعبر عن مقاومته للبريطانيين وسياساتهم. وعندما شن حملة ضد استيراد المنسوجات البريطانية حاز على تعاطف حتى عمال النسيج البريطانيين أنفسهم الذين فقدوا أعمالهم بسبب المقاطعة الهندية. وأثبتت حياته وأعماله أننا لا نحتاج إلى إصدار أحكام على الآخرين كي نهزمهم! إننا نحتاج لأن نتخذ موقفا ثابتا قائما على قناعاتنا، وأن نسعى إلى حلول توفيقية دون إيذاء الآخرين من أجل كسب تعاطفهم وتفهمهم. وقال غاندي: ’’إن أقسى قلب وأغلظ جهل يجب أن يختفيا أمام شمس معاناة تسطع بغير غضب وبغير دهاء‘‘.
وقال غاندي: ’’إن اللاعنف هو قانون نوعنا البشري وأن العنف هو قانون الوحوش. أن الروح تغفو نائمة في الوحش الذي لا يعرف إلا قانون القوة المادية. أما كرامة الإنسان فتتطلب طاعة قانون أعلى – طاعة قوة الروح‘‘. وقال أيضا عن قوة الروح: ’’إنها قوة يمكن أن يستخدمها الأفراد وكذلك الجماعات. ويمكن أن تستخدم في الشؤون السياسية وكذلك في الشؤون المنزلية. وقابليتها للتطبيق العالمي دليل على ديمومتها وعلى أنها قوة لا تقهر. ويمكن أن يستخدمها الرجال والنساء والأطفال على حد سواء. ومن غير الصحيح تماما القول بأنها قوة لا يستخدمها إلا الضعفاء ما داموا عاجزين عن مواجهة العنف بالعنف‘‘.
وقال وهو يتحدث عن الحركة السياسية التي أسسها لتحرير الهند: ’’إن ساتياغراها حركة معتدلة لا تؤذي أبدا. ويجب ألا تكون نتيجة الغضب أو الدهاء. وهي ليست أبدا سريعة الاستثارة أو قليلة الصبر أو شعواء الصخب. إنها النقيض المباشر للإكراه. لقد ابتكرت كبديل للعنف‘‘.
رؤية الوحدة في التنوع
إن إصدار الأحكام إذن، سواء كان يتعلق بمشاعرنا الشخصية إزاء الآخرين، أو بنظرتنا إلى الله وإلى رحلة روحنا الأخيرة، ليس هو القول الفصل. فالحكماء ومن امتلأت قلوبهم بالمحبة والأبطال الروحيون لحضارتنا، من بوذا إلى المسيح إلى المهاتما غاندي، قد اكتشفوا أن الحب والغفران والرحمة وعدم الإيذاء صفات يجب أن تحل محل إصدار الأحكام. وإصدار الأحكام لا يحرمك من صفاء الذهن فحسب، بل إن تكلفته قد تكون أيضا باهظة. إذ أنه علاوة على إيذائه الآخرين ينعكس عليك أيضا. وقد سمى معلمو اليوغا، السِيدا الحكماء، الله ’’الخيرَ‘‘ وقالوا إننا جميعا جزء من أسرة واحدة وأرض واحدة. إن الحكيم يرى الخير في الآخرين ويبتعد عما سواه. إن إصدار الأحكام يُقسِّم. أما الحب فيُوحِّد. إن المحبة والغفران يتجاوزان القانون ويوجدان منظورا جديدا نبصر من خلاله الوحدة الجوهرية للجميع.
حقوق المؤلف محفوظة لـ: م. غوفيندان ساتشيدانندا. ربيع عام 2008
في سبعينات القرن العشرين، تناول كتاب من الكتب أكثر رواجا عنوانه ’’أنا على ما يرام، أنت على ما يرام‘‘، شأنه شأن الكثير من الكتب التي أخذت تصدر منذ ذلك الحين، العلاقات البشرية وكيفية الاستفادة منها إلى أقصى حد. ويعبر عنوان الكتاب عما يفعله معظمنا طول الوقت: إصدار الأحكام على الآخرين. ومما يؤسف له أن معظم أحكامنا ليست ’’على ما يرام‘‘، بل تشكل بالأحرى آراء تؤذي الآخرين وتؤذينا. ومن ثم تصبح العلاقات بين الناس مصدرا لانقسام وصراع كبيرين. وفي العقود الماضية، ركز جانب كبير من علم النفس على تحسين علاقاتنا الاجتماعية، وإدارة الصراع، وعلى جعل شخصياتنا مقبولة بقدر أكبر من الناحية الاجتماعية. غير أن دور إصدار الأحكام في علاقاتنا الاجتماعية ليس مفهوما على نطاق واسع.
التعاطف والنفور
أوضحت الدراسات في مجال علم النفس أن معظم الأشخاص يُكوِّنون انطباعات دقيقة إلى حد معقول عن الآخرين في غضون دقائق قليلة. كما لو كان الكائن الإنساني لديه القدرة على أن يجري مسحا سريعا للآخرين ويستوعب، ولو حدسا، كثيرا من السمات الصحيحة. غير أن هذه الانطباعات تستثير أحكاما تصطبغ عادة بميول الفرد ومشاعره. فقد أظهرت مثلا دراسة حديثة عن المقابلات التي تجرى لتعيين الموظفين أن المرشحين الذين كانوا متعاطفين مع من أجروا لهم المقابلات كانوا هم الذين يقع عليهم الاختيار عادة للوظائف المطلوبة حتى وإن لم تكن إجاباتهم ومؤهلاتهم كافية في كثير من الأحيان، في حين أن المرشحين الذين كانوا يشعرون بشئ من النفور ممن أجروا لهم المقابلات لم يحالفهم النجاح حتى وإن كانت إجاباتهم ومؤهلاتهم جيدة على نحو استثنائي. ويبين هذا أن من أجروا المقابلات كونوا عن المرشحين أحكاما تستند إلى عوامل ذاتية، تشمل المشاعر، بل والحدس، أكثر مما تستند إلى عوامل موضوعية. ويوضح ذلك أن لدينا القدرة على استشعار الأحكام التي يضمرها الآخرون عنا.
ما المقصود بالأحكام:
الأحكام آراء تُكوَّن استنادا إلى تجارب محدودة، بل وإلى الإشاعات أحيانا. فهي لا تستند إلى وقائع، وتنحو إلى التيبس في شكل حقيقة ثابتة حتى قبل تقييم الوقائع المعنية. بل والأسوأ أنها تستند في كثير من الأحيان إلى التعصب والخوف والتخيل. أفلا يشعر البعض مثلا برد فعل فوري عندما يرون رجلا وامرأة من لونين مختلفين يتحدثان حديثا حميما.
الحكم السديد:
إن التحدي المطروح علينا ليس تجنب إصدار الأحكام بقدر ما هو تكوين ’’الحكم السديد‘‘. و’’الحكم السليم‘‘ صفة تحظى بإعجاب كبير، غير أن أصول الحكم السديد ليست مفهومة بصورة جيدة. فهو نتيجة تفكير وتدبر، وهو مشبع بالحس السليم، إن لم يكن بالحكمة. وهو متحرر من الانفعال والتعصب. كما أنه يقوم على حصافة الفكر بسعيه إلى الموازنة بين كل العوامل ذات الصلة. وهو ’’سديد‘‘ لأنه ينهض بكل المعنيين به. فهو يرفع المعنويات ويجلب البهجة، ولا يتسبب أبدا في إلحاق الأذى. فقد يقول صديق شيئا صادقا لصديقه ولكن الأخير قد لا يكون مستعدا لسماعه. وعندئذ يرفضه وينشأ صراع، بل وقد يفقدان صداقتهما. ومن ثم فإن ’’الحكم السديد‘‘ يعبر عن نفسه بطريقة تسعى دوما إلى تخليص كل المعنيين من المعاناة، بل وإلى تحقيق البهجة. وهو نتيجة ذهن وصل إلى حقيقة وضع ما، من خلال الحدس أو التجربة أو المهارات التحليلية القوية. إن الحكم السديد هو في كثير من الأحيان ثمرة التجارب، ولذا يعتبر كبار السن متحليين عادة بقدرة على الحكم السديد أكثر من الشباب الذين تكون أحكامهم متشربة في كثير من الأحيان بالإثارة الانفعالية أو بروح التمرد. وعلاوة على ذلك، ينسب ’’الحكم السديد‘‘ إلى الحكماء الذين يبدو أن لديهم صلة خاصة بحقيقة الأشياء، وقدرة حدسية على لمس أصل الوجود، ذلك الذي يبقى بعد فناء كل شئ.
لماذا يعد إصدار الأحكام مؤذيا؟
يعد إصدار الأحكام مؤذيا بوجه عام للأسباب التالية. أولا، إنه يعبر عن الحالة الذهنية للشخص الذي يصدرها. وقد أوضحت الدراسات النفسية أن الشخص العادي ينفق أكثر من ثلثي وقته في حالة ذهنية أو انفعالية سلبية. فمشاعر الاكتئاب والحزن والخوف والعجلة والغرور تسيطر على الشخص العادي. وإلى أن يتعلم المرء كيف يتحكم في هذه الحالات، يعبر ما يصدره من أحكام عادة عن هذه الحالة الخاصة به. أي أننا نسقط على الآخرين ما نشعر به نحن. ونفترض أنهم يشعرون بما نشعر به، لأن إدراكنا يكون متأثرا بحالتنا الداخلية. إن أحكامنا تؤذي الآخرين لأننا نسقط عليهم رد فعل سلبيا، إن لم يكن رد فعل خاطئا.
وثانيا، تسبب الأحكام الأذى لأنها تفترض أن الحالة المعنية تظل ساكنة. فعندما نصدر حكما عن شخص آخر، يكون هناك افتراض ضمني بأن الشخص الذي نحكم عليه لن يتغير على الأرجح. ومع أن الطبيعة البشرية تعد ثابتة عموما إلا أنها تتغير في كثير من الأحيان. فالناس يمرون بأيام سيئة ومآس وفورات انفعالية. ويكون سلوك عندئذ غير معتاد ولا يعبر عن شخصيتهم الكامنة خلف السطح. ولذا فإن إصدار أحكام عن أناس يمرون بأوقات عصيبة أمر خاطئ. فالشباب يتجاوزون سلوكهم غير الناضج مع تقدمهم في العمر. وأقوياء الإرادة يتغلبون على الميول السلوكية السيئة ويصلحون من أنفسهم. ومن ثم فإن إصدار أحكام ثابتة لا يفسح مجالا للنمو، وللتغير في اتجاه إيجابي، ولذا تتسبب في إلحاق الأذى. فالأحكام تخلط عادة بين الأشخاص وسلوكهم. ويحتاج المرء إلى التحلي بالحكمة لإدراك الفرق. فبالحكمة يدرك المرء أنه ليس جسده ولا ذهنه ولا شخصيته، فتلك الأمور أشبه بالملابس التي نستطيع تغييرها أو التي قد نحتفظ بها بحكم العادة. وبالحكمة يدرك المرء أن هويته الحقيقية هي وعي خالص، هي الروح، الرائي أو الشاهد، وأنه لديه القوة لتغيير السلوك المعتاد بممارسة إرادته.
وثالثا والأهم، تسبب الأحكام الأذى لأنها تعزز الصفة المدانة، لا في الشخص المحكوم عليه فحسب، بل أيضا، وهذا أكثر دلالة، في الشخص الذي يُصدر الحكم. فعندما نصدر حكما عن شخص آخر، معتقدين أن ’’ذلك الشخص جشع‘‘، فإننا نستغرق من الناحية الفعلية في صفة الجشع، ولذا نعززها في أنفسنا. وهذا أمر يذكر بالقلق الذي يمكن تعريفه بأنه ’’التفكير فيما لا ترغب فيه‘‘، فالحكم على الآخرين هو التفكير فيما لا ترغب فيه في نفسك.
ويقول ’باتنغالي‘، وهو أحد آباء اليوغا الكلاسيكية وكان معاصرا للمسيح: ’’عن طريق إنماء مواقف الصداقة تجاه السعداء، والمحبة تجاه التعساء، والابتهاج تجاه الفضلاء، والاتزان تجاه غير الفضلاء، يعود الوعي إلى الهدوء الذي لا يزعجه شئ‘‘ (’اليوغا سوترا‘، الفصل الأول، القول الثالث والثلاثون). وعندما لا نفعل ذلك، ما الذي يحدث؟ يصبح ذهننا قلقا وحافلا بالأحكام والمشاعر السيئة والضغينة والغضب والاشمئزاز. وبالتالي، نفقد الشرط الأساسي لتحقيق الله: أي الهدوء والسلام والنقاء الداخلي والبراءة. إن العالم في داخلنا. ولتغيير العالم من مكان ملئ بالشر إلى ’’جنة السموات‘‘ علينا أن نغير أفكارنا. تغافل إذن عن نواقص الآخرين. ولا تستغرق في نقاط ضعفهم. فإن ذلك يقوي هذه النقاط.
’أهيمسا‘، اللاأذى، دواء إصدار الأحكام
كيف يمكن تجنب إصدار الأحكام التي تؤذي الآخرين؟ يخبرنا الحكماء بأننا نحتاج إلى إنماء موقف اللاأذى، الذي يطلق عليه في الهند اسم ’أهيمسا‘. ويشمل اللاأذى، عدم إلحاق الأذى بالأفكار أو بالكلمات أو بالأفعال. وهو يستند إلى الاعتراف بأن هناك عواقب أو ’كارما‘ تنتج حتى من الأفكار. فالأفكار، كثيرا ما تكرر بحكم العادة، والعادة تُوجِّه بعد ذلك حياة الفرد. وإذا كانت العادة تنطوي على رغبة ولم يتسن إشباع هذه الرغبة، تخبط المرء في وهدة الإحباط لأنه لا يدرك أن مصدر السعادة في الحياة وهو الفرحة الداخلية الدائمة للروح.
لقد قال المسيح عندما وضعوه على الصليب: ’’يا أبتاه، أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون‘‘، واصفا من حكموا عليه هذا الحكم القاسي. فبدلا من أن يكون غاضبا عليهم، أو مستغرقا في آلامه، كان أكثر انشغالا بالعواقب ’الكارمية‘ لأفعال مضطهديه. إذ كان يعرف فيما يبدو أن العواقب ستكون قاسية وفقا لقانون ’الكارما‘، ولم يُرِد لهم أن يعانوا بسببه. ولذا دعا أباه أن يغفر لهم. إن الغفران ينبع من الحب لا من إصدار الأحكام. لقد كان ذلك نموذجا أسمى لما أوصى به ’باتنغالي‘ في ’اليوغا سوترا‘: ’’عندما تكون ممتلئا بالمشاعر السلبية، طور المشاعر المعاكسة‘‘. كما أتاح الغفران للمسيح أن يجد السلام، وأن يتحرر من آثار الغضب المدمرة.
إن مباركة الآخرين، ومحبة الآخرين، هو دوما بديل أفضل من إصدار الأحكام عليهم. إن أفكارنا ودعواتنا لها تأثير فعلي على الآخرين، ونستطيع أن نحقق فرقا في حياتهم بالأفكار والدعوات الطيبة. وعلى المستوى الخفي الباطن، تكون للأفكار حياة خاصة بها. فعندما نفكر في الآخرين، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ننتج صورا من الأفكار تلتصق بهؤلاء الأفراد وتؤثر على سلوكهم وتجاربهم. ومثال ذلك، أن امرأة اكتشفت أن زوجها يخونها بعد زواجهما ببضعة أسابيع، فدعت عليه بالموت. وبعد عدة أيام، مات زوجها في حادث مرور فصل فيه رأسه عن جسده. ووقعت العروس الشابة نهب مشاعر الذنب إلى درجة أنها ظلت تتخيل طوال عام كامل أنه ما زال يعيش معها، فكانت تعده له وجباته وتقدمها له كما لو كان حيا، إلى أن نجحت أسرتها في إقناعها بأن عليها أن تلتمس مشورة نفسية.
وقد أتاحت بحوث أجريت في جامعة دوك بالولايات المتحدة التحقق من أن الصلاة تعد فعالة في مساعدة المرضى على التعافي من أمراضهم، وأحيانا بشكل معجز. ففي معظم الحالات، يتقلص الوقت اللازم للنقاهة بقدر كبير عندما يصلي الآخرون من أجل شفائك. وعلى مستوى علوم الباطن، يُولِّد الدعاء أشكالا قوية من الأفكار يمكن أن تساعد الآخرين. ومن الأمثلة على ذلك أن امرأة اصيبت إصابة خطيرة في حادث مرور كانت قد لاحظت بشكل عابر أثناء إصابتها أن شخصا غريبا عنها تماما يدعو لها بالسلامة، وقد تعرفت فيما بعد على هذا الشخص عندما زارها في المستشفي للاطمئنان عليها. وقالت السيدة إن دعاءه هو الذي أنقذ حياتها. ولذا يجب، كمسألة روتينية، أن نبارك الآخرين وأن ندعو لهم، بشكل صامت ودون إعلان، متى رأينا شخصا يعاني بشكل أو بآخر. إن لدينا جميعا فرصا كثيرة لنفعل ذلك. فمثلا ونحن نقود سياراتنا، عندما يقطع علينا شخص ما الطريق، أو عندما نبصر مارا حزينا أو مضطربا، نستطيع أن نقول ’’فليبارك الله هذا الشخص‘‘. أو ’’فليساعد الله هذا الشخص على العثور على السلام‘‘، أو على ’’أن يبطئ سرعته‘‘ أو ’’أن يجد السعادة‘‘. ونستطيع أن نفرح مع الآخرين في حظوظهم الحسنة بدلا من الشعور بالحسد منهم ولنقول: ’’فليبارك الله هذا الشخص. ولتتوالى عليه نعم الله، وليتقاسم هذه النعم مع الآخرين‘‘.
الحكم النهائي أم الغفران؟ من أقوال وأمثال المسيح
قال المسيح: ’’بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم‘‘ (متى 7: 1-2). كان المسيح يتحدى القاعدة الدينية السائدة في ذلك الوقت. فاليهودية كانت دينا تشريعيا. وكان الله هو المشرع، وأعطى موسى الوصايا العشر على جبل سيناء. وكان الله هو الحَكَم النهائي، وكان يُعتقد أنه يدين الذين يخالفون قوانينه، ويثيب من يحترمونها. وكان هذا تقدما بالقياس إلى أديان أخرى مثل دين الكنعانيين الذين كانوا يعبدون صنما على شكل بقرة ذهبية. والأديان البدائية يحركها الخوف، وخاصة الخوف من الموت أو الألم. ولذا يحاول الرجل البدائي أن يهدئ، بتقديم القرابين، ما كان يعتبره مصادر فوق طبيعية للأحداث والظواهر تهدد حياته. وفي وقت لاحق، عندما نظم الناس أنفسهم في مجتمعات، وضعت المجتمعات قوانين لتجنب أن يُلحق الناس الأذى ببعضهم بعضا، ولتنظيم السلوك البشري بأعراف اجتماعية. ولما كانت هذه القوانين تحتاج إلى سلطة نهائية، عمد الحكام، أي الملوك والزعماء عامة، إلى نسبة سلطتهم إلى الله. ومع ذلك الناس كانوا يرتكبون جرائم القتل دون أن يحاكموا، وكانت الأشياء السيئة تحدث للأخيار، وبغية الحفاظ على الإحساس بالعدل، خلق الإنسان صورة الله العادل، الحاكم النهائي، الذي يعاقب الشرير ويثيب الخير. فنحن نجد مثلا في العهد القديم كثيرا من الأنبياء يتحدثون عن ’’يوم الحساب‘‘، وفي الهند نجد مفهوم ’’برارابها كارما‘‘ الذي تكون بمقتضاه لأعمال المرء في حياته عواقب في حياته التالية. وعليه، فإن الناس في هذه المرحلة من الدين، حاولوا أن يوازنوا سيئاتهم، أو ’الكارما‘ السيئة، بأشياء تكفر عن ذنوبهم. ووسائل ذلك يمكن أن تكون بسيطة مثل التوبة وإنكار الذات الطوعي، أو قد تكون، كما في مسيحية العصور الوسطى، بتقديم العطايا للكنيسة.
وقال المسيح: ’’ولماذا تنظر للقذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تنظر لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك‘‘ (متى 7: 3-5). أي بعبارة أخرى، ينبغي أن يركز المنتقدون على تصحيح أنفسهم. كما قال: ’’لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل‘‘ (متى 5: 17-20). فما معنى هذا؟ المسيح لم يقل تجاهلوا الشريعة أو الناموس، بل ادركوا أن الله يحبكم. وعمد المسيح مرارا وتكرارا إلى ضرب الأمثال، كمثل الابن الضال (في لوقا 15: 11-32) من أجل توضيح هذه ’’البشارة‘‘. ولأن الله يحبكم تستطيعون أن تحبوا الآخرين. والله الذي يحبكم لا يمكن أن يحكم عليكم باللعنة الأبدية! كانت هذه هي أهم تعاليمه. وحث تلاميذه وأتباعه مرارا على أن يحبوا بعضهم بعضا، وأن ينقوا أنفسهم من التعلق بالماديات، كي يدخلوا ملكوت السموات، الذي قال إنه يحيط بنا من كل جانب، إن تمكنا من إنماء نقاء البصيرة الذي يسمح لنا بأن نبصره (لوقا 17: 20-21). وقال المسيح إننا يجب أن نكون أبرياء مثل الأطفال الصغار إذا أردنا أن ندخل ملكوت السموات. وقال ’’أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم‘‘ (لوقا 6-27). وقال ’’من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا‘‘ (لوقا 6-29). الحب يسبق إذن الشريعة والحكم. قد يكون من حقك أن تطالب بأن تكون ’’العين بالعين‘‘ كما يدعو أنبياء العهد القديم، لكن المهاتما غاندي يقول: ’’قصاص العين بالعين يترك العالم كفيفا في نهاية المطاف‘‘. أي عندما يعمينا إصدار الأحكام والانتقام لا نبصر الحقيقة النهائية وهي أننا جميعا أفراد في أسرة إنسانية واحدة، وأنه من خلال الحب يمكن التغلب على كل الاختلافات.
المهاتما غاندي: رسول اللاعنف المعاصر
قال المهاتما غاندي: ’’كل الذنوب ترتكب سرا. وما أن ندرك أن الله يراقب حتى أفكارنا نكون أحرارا‘‘. أي إن الذنب هو غياب الوعي بحضور الله. ولذا فإن إصدار الأحكام على الآخرين بسبب ذنوبهم، يعمينا عن ذنوبنا نحن! لقد كان غاندي تلميذا عصاميا للحقيقة نجح أخيرا في عام 1947، بعد أربعين عاما من الكفاح، في إجبار الإمبراطورية البريطانية على الرحيل عن الهند بلا عنف، عن طريق إحياء مبدأ ’’الهيمسا‘‘ القديم، أو مبدأ ’’عدم الإيذاء‘‘. وقد ابتكر غاندي أساليبه في تطبيق هذا المبدأ عن طريق دراسة ’الجاينية‘ وأمثال المسيح، اللتين تركزان على عدم الإيذاء. فنساك ’الجاينية‘ يرتدون أقنعة على أفواههم ويكنسون الأرض قبل سيرهم عليها لتجنب قتل حتى الحشرات عن غير قصد. وأصبحت أساليبه القائمة على عدم الإيذاء، أو ’’الهيمسا‘‘، أساس حركة الحقوق المدنية التي استحدثها مارتن لوثر كنغ في الولايات المتحدة في ستينات القرن العشرين، وفي غيرها من الحركات النقابية والاجتماعية الأخرى التي استخدمت المقاومة السلبية والاحتجاجات والمظاهرات اللاعنيفة من أجل توعية الجمهور بقضاياها. وفي الهند، شارك آلاف الرجال والنساء في حركة ’’ساتياغراها‘‘ التي تدعو إلى العيش وفق مبادئ الحقيقة (ساتيا) دون إيذاء الآخرين. وفي المظاهرات الضخمة التي اندلعت ضد الجيش البريطاني الاستعماري، تعرض الآلاف للضرب حتى الموت أو التشويه دون إبداء أدنى قدر من المقاومة. لقد بلغ إصرارهم على إدارة الخد الآخر حدا أجبر البريطانيين أخيرا على التخلي عن حكمهم الاستعماري للهند الذي دام أكثر من 300 عام. وقضى غاندي عقودا داخل السجون البريطانية، صائما لفترات طويلة، كي يعبر عن مقاومته للبريطانيين وسياساتهم. وعندما شن حملة ضد استيراد المنسوجات البريطانية حاز على تعاطف حتى عمال النسيج البريطانيين أنفسهم الذين فقدوا أعمالهم بسبب المقاطعة الهندية. وأثبتت حياته وأعماله أننا لا نحتاج إلى إصدار أحكام على الآخرين كي نهزمهم! إننا نحتاج لأن نتخذ موقفا ثابتا قائما على قناعاتنا، وأن نسعى إلى حلول توفيقية دون إيذاء الآخرين من أجل كسب تعاطفهم وتفهمهم. وقال غاندي: ’’إن أقسى قلب وأغلظ جهل يجب أن يختفيا أمام شمس معاناة تسطع بغير غضب وبغير دهاء‘‘.
وقال غاندي: ’’إن اللاعنف هو قانون نوعنا البشري وأن العنف هو قانون الوحوش. أن الروح تغفو نائمة في الوحش الذي لا يعرف إلا قانون القوة المادية. أما كرامة الإنسان فتتطلب طاعة قانون أعلى – طاعة قوة الروح‘‘. وقال أيضا عن قوة الروح: ’’إنها قوة يمكن أن يستخدمها الأفراد وكذلك الجماعات. ويمكن أن تستخدم في الشؤون السياسية وكذلك في الشؤون المنزلية. وقابليتها للتطبيق العالمي دليل على ديمومتها وعلى أنها قوة لا تقهر. ويمكن أن يستخدمها الرجال والنساء والأطفال على حد سواء. ومن غير الصحيح تماما القول بأنها قوة لا يستخدمها إلا الضعفاء ما داموا عاجزين عن مواجهة العنف بالعنف‘‘.
وقال وهو يتحدث عن الحركة السياسية التي أسسها لتحرير الهند: ’’إن ساتياغراها حركة معتدلة لا تؤذي أبدا. ويجب ألا تكون نتيجة الغضب أو الدهاء. وهي ليست أبدا سريعة الاستثارة أو قليلة الصبر أو شعواء الصخب. إنها النقيض المباشر للإكراه. لقد ابتكرت كبديل للعنف‘‘.
رؤية الوحدة في التنوع
إن إصدار الأحكام إذن، سواء كان يتعلق بمشاعرنا الشخصية إزاء الآخرين، أو بنظرتنا إلى الله وإلى رحلة روحنا الأخيرة، ليس هو القول الفصل. فالحكماء ومن امتلأت قلوبهم بالمحبة والأبطال الروحيون لحضارتنا، من بوذا إلى المسيح إلى المهاتما غاندي، قد اكتشفوا أن الحب والغفران والرحمة وعدم الإيذاء صفات يجب أن تحل محل إصدار الأحكام. وإصدار الأحكام لا يحرمك من صفاء الذهن فحسب، بل إن تكلفته قد تكون أيضا باهظة. إذ أنه علاوة على إيذائه الآخرين ينعكس عليك أيضا. وقد سمى معلمو اليوغا، السِيدا الحكماء، الله ’’الخيرَ‘‘ وقالوا إننا جميعا جزء من أسرة واحدة وأرض واحدة. إن الحكيم يرى الخير في الآخرين ويبتعد عما سواه. إن إصدار الأحكام يُقسِّم. أما الحب فيُوحِّد. إن المحبة والغفران يتجاوزان القانون ويوجدان منظورا جديدا نبصر من خلاله الوحدة الجوهرية للجميع.
حقوق المؤلف محفوظة لـ: م. غوفيندان ساتشيدانندا. ربيع عام 2008